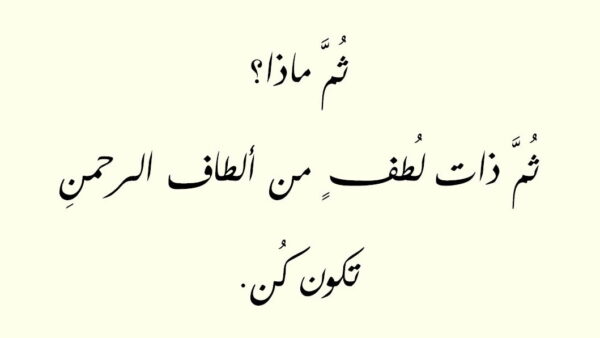الأستاذ العزيز، أستاذ اللغة العربية الذي أحبّ أن أقرأ يوميّا جديد قلمه، الأستاذ الصّامد في البلاد رغم كلّ ما جرى على العباد ويجري حتّى الآن، أريد أن ألقي عليك التّحيّة والسلام، أحبّ أن أحيّيك بأطيب التحيّات تحيّة أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
سلامٌ سليمٌ على قلوب السوريّين في الداخل والخارج فوق الأرض وتحت الأرض إلى يوم يبعثون..
سلامٌ على أعراف المشاعر الذين تساوت أفراحهم بآلامهم فما أقعدهم الوجع مع القاعدين، وما ثبّطت عزيمتهم مصائب تتوالى علينا تباعاً منذ عشر سنين..
تقول أنّها كانت أربعين، وتقول أنّها كانت أكثر ممّا ذكرتُ بكثير، وأقول أنّي أعرفُ فلقد رأيت؛ ربّما ما سمعت عنه في الطفولة لم أشعر وجعه كما أشعره الآن؛ لن تدرك وجع الجوع ما لم تقرص أحشائك قرصته، لن تعي معنى الموت قبل أن يمسّ حبيباً كنت تتمنّى عبثاً أن لا مساس له.
أستاذي العزيز..
هل يبدو هذا الفضاء الرّقميّ افتراضياً تماماً؟ هل لا نشعر بالنّاس من خلف الشاشات؟ هل يتسلّى الجميع؟ هل كان للبعض رسائل قيّمةٌ حقاً؟ هل كنّا نحترم مساحة الآخر حين كان يحبّ أن يتنفّس دون أن يؤذي أحداً ببضعة أنفاسِ كتابةٍ انطباعيّة لا أكثر؟ قل لي بربّك إلى أين يمضي بنا هذا الطّوفان؟
لديّ أسئلةٌ مزعجة كثيرة أودّ أن أسألك إياها، لديّ أكوام أحاديث كنت أتمنّى لو أنّ الزّمان يرجع بي إلى الوراء اثنتي عشرة عامٍ كي نلتقي صدفة، أن أستقلّ تلك الحافلة التي تنطلق ما بين حلب والشام، أن أتوقّف لأوّل مرّة في العديّة التي لم أعرفها إلا من وراء زجاج نافذةٍ لم تمنع روحي بأن تتمشّى فيها قليلاً أثناء استراحة منتصف الطّريق، وأريد أن أسألك السؤال الأزليّ الأبديّ الجوهريّ الكارثيّ المعهود فلربّما كنت تملك اجابته السّريّة: هل كانت حلاوة الجبن حمصيّة المنشأ أم حمويّة؟ هل كنّا نستحقّ أن تقوم هذه القيامة في بلادنا ونحن أهل اللطف والبساطة وخفّة الروح والكرم؟ نحن الذين قالوا: “مين تذكّرني بفستقة كنت عنده عزيز”، و”بيت الضيق بيسع ألف صديق”.
ماذا حلّ بنا يا أستاذ؟ ماذا حلّ؟
بماذا أجيب ذلك الطفل الذي يسألني كلّ حنين متى يرى بلداً يسمع بأنّها بلده؟
كيف سأخبر أحفادي حين يولدون في بلاد العمّ سام بعد سنين بأنّهم حتّى وإن نطقوا لغة غير لغتهم ولهجوا لهجة غير لهجتهم وحملوا جنسيّةً جديدةً تماماً لا تمتُّ لعرين العروبة بشيءٍ أنّ خفق الفؤاد لن يبرح أفئدةً تعود أرواحها إلى الشّام وأهل الشام وكلّ ما يعشق الشام.
يا أيّها الأستاذ سامحني، سامحنا فدتك الروح ما ضاق عليك الصّباح وظننت أنّ النّهاية تقترب وأنّ النفس تكاد تختنق، أريد أن أخبرك شيئاً، لنعتبره ثرثرة جارين عند باب العمارة، أو أستاذين في غرفة المعلّمين في المدرسة، أريد أن أقول أنّي أمٌ والأمّهات لا تنسى..
في ذلك اليوم كتبت عن العنب، كتبت عن ظلم الغلاء وجنون ارتفاع الأسعار، كتبت أنّ أحدهم في بلادي التي ما عادت بلادي لم يتذوّق العنب هذا العام، تذوّق حبّةً واحدةً وحيدةً فقط أثناء شراء الخضار ومضى بشموخٍ كما يمضي الكرام أبناء الكرام، لأنّ عجلة الحياة لن تتوقّف أبداً عند أسرةٍ عفيفةٍ من أجل عنقود عنب.
هل تعرف مثل ماذا فعلت تلك الكتابة؟
هل تدرك أنّي بكيتُ حتّى تمنّيت أن أتجاوز حدود المرسال الفوريّ البنفسجيّ لأكتب لك سامحنا لأنّا لا نملك أكثر من شعور الإنسان بأخيه الإنسان، وسامحنا لأنّا لا نملك أغلى من دعاء الأمّهات أن تنفرج الصخرة التي انحدرت وأطبقت علينا ذات امتحانٍ من الرحمن، سامحنا لأنّ أحدهم مشى في أرجاء البلاد وراح يحكي بهتاناً قصّةً خرافيّةً عن نقودٍ تمطر من سماء الخليج وأوروبا على المغتربين صباح مساء دون إكمال الرواية وقصّ تفاصيل الحكاية.
أريد أن أقول أن الإنسانية تصرّفٌ لا صفُّ كلمات، أريد أن أقول لك أن ابنتي أوقفتني في السوق بعد قراءة ما كتبتَه بيومين: “ماما، شوفي هاد العنب ما أحلى لونه”.
تلك عبارة يقولها الأطفال “أدباً عن” أو لنقل “بدلاً من”: ماما هل تشتري لنا ذلك؟
اكتفيتُ بقول: ما شاء الله، سبحان الله؛ مضينا بلا عنب، وحكيت لهم ما قرأت لك أثناء طريق عودتنا إلى البيت؛ لا أعرف إن كانت الأمّهات بحاجةٍ ملحةٍ حقاً لكلّ هذا الكمّ المهول من الدورات لتعلّم التّربية، لكنّي بعد ستّة عشر عامٍ وطفلين وجدتها وجداناً أكثر من أيّ فلسفةٍ أُخرى.
في الحقيقة يا عمّ، لست أنا من لم تشترِ العنب كرمىً لعيني أهل بيتك ومشاركةً شعوريّةً عن بعدٍ لمن لم تُعرف وجوههم يوماً أيضاً، تلك قصّةُ حبٍ حقيقيٍّ من بين آلاف القصص ليس إلا.
أذكر تماماً أنّ جارنا كان لا يقبل أن يرسل مع طفلته موزةً إلى المدرسة خشية أن يشتهيها طفلٌ لم يقدر على شراء مثلها له أهله؛ وأذكر والدي جعل الله له نوراً كم كان يحبّ التفّاح الأخضر، وكيف أنّه كان آخر ما طلب تذوّقه في هذه الحياة السّريعة، طلب بالاسم “تفّاحةً خضراء”، لا أعرف سرّ ذلك الطّلب حتّى الآن، لكنّي أتذكّر تماماً كلّ المرّات التي دمعت فيها عيناه في العمر، عاد مرّةً إلى البيت وجلس إلى طاولة الطّعام وأزاح عن عينيه النّظارة ووارى وجه النور بكفّيه الأجمل، مسح الدمعتين ومثلك يعرف حقّ المعرفة ما معنى أن يدمع الآباء دمعتين، وضع أمامه كيسَ التّفاح، يقول بأنّه سمع طفلاً خلفه يقول لوالده: “بابا بدنا من هاد التّفاح”، يقول بأنّه سمع الوالد يجيب: “يا بابا هاد التّفاح مو قدرتنا هلأ، نحن قدرتنا الأحمر والأصفر، هاد بده شويّة شغل أكتر”.
يقول بأنّ الموقف كان موجعاً إلى حدٍّ أربكه، بأنّه لم يستطع أن يرى أصحاب الصّوت، وبأنّه سارع لتعبئة كيس تفاحٍ أخضرٍ ثانٍ كي يتحيّن لحظة انشغال الأبّ بتعبئة الخضار في الأكياس ويهديه للطفل الصّغير دون أن تلمح عيناه عينا والده احتراماً، وأن يمضي بعدها برضاً مطلقٍ دونما أسفٍ كما يُفترض بالحبّ الحقّ أن يمضي بين البشر في الحياة.
أيّها العمّ العزيز، أرأيت ماذا يكتبون؟ هل يؤذي قلبك ما يؤذي قلبي؟ هل أصبحت رياحيننا ثقيلة الظلّ إلى هذا الحدّ على بعض الشعوب؟ كيف غصّت عينٌ عن موزة لاجئٍ ومهاجرٍ وشريدٍ وطريد!
يقول رسولنا الكريم: “من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه”، هل كانت حقاً تعني لهم كثيراً هذه الموزة؟ أم أنّها لم تكن أكثر من أحاديث الشوارع؟ لست أدري؛ الذي أدريه أنّه لن يحسّ بابن البلد مثلُ ابن البلد، والذي أعرفه أنّي أحاول أن أربّي بالحبّ أبناءً تحسّ مثل ذلك، والذي أدعوه أن يصلح الله أحوالنا وأحوالكم وأحوالهم، وأن ننسى، أن يعطينا حتّى نرضى، أن نعود، أن نزورها يوماً مّا، أن أنزل والطفلين في حمص، أن أحكي لهم حكاية الضحكة الأولى، أن نزور الأستاذ في المدرسة، أن نقول: هذا الإنسان يحيّي الإنسان، هل تقبل دعوتنا على حلاوة جبنٍ قطرها يسرّ النّاظرين مع كأسِ شايٍ مخمّرةٍ أمرّ من ما مرّ علينا حتى اليوم، علّ الفستق يُنسينا بعضاً من هذا الذي مرّ؟ أتمنى، كم أتمنّى، الله الكريم، كن بخير، كلّ خير.
إنسان